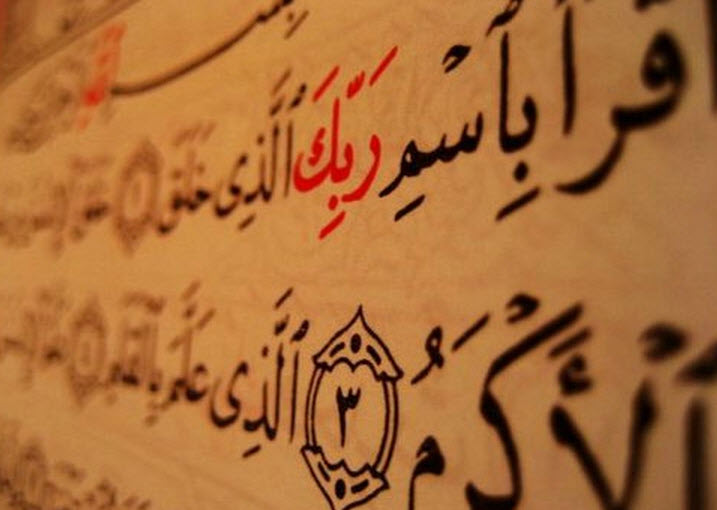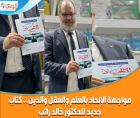- الثلاثاء، 01 سبتمبر 2015 07:36
- كتب بواسطة: adminkw
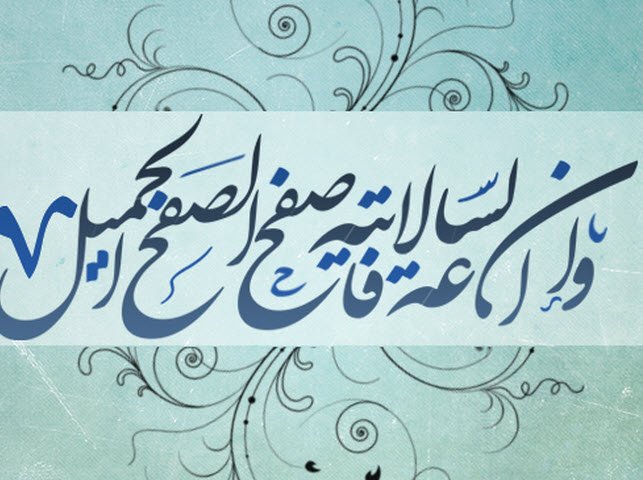
محمود توفيق :
في كتاب الله سبحانه وتعالى فيض من تأديب الله عز وجل لنبيه " صلى الله عليه وسلم" ، ثم لورثته من أهل العلم والدعاة إلى الله جلّ جلاله. وهداية له إلى ما يمكّنه من القيام بحق ما كلف به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.
ومن هذا ما جاء في سورة «الحجر»، من أمر الله سبحانه وتعالى نبيه سيدنا محمدًا " صلى الله عليه وسلم" بأن يصفح صفحا جميلا.
يقول الله سبحانه وتعالى: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) } (الحجر: 85- 87).
في تصدير الآية بالحقيقة الكونية: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ}، وبالحقيقة العقدية: {وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ}، من قبل التـكليف بالصفح الجميل، ثم بالحقيقة العقدية أيضا: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ}، ثم بالمنة العظمى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}، في كل ذلك تثقيف للنفس، لتتلقى هذا التكليف الثقيل: {فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} تلقي أولي العزم من الرسل.
ذلك أن الصفح الجميل، لايتأتى إلا بعظيم من اليقين، وبعظيم من المثابرة ومن الصبر الجميل أيضا. فالنفس البشرية مفطورة على أن تنتقم لنفسها إن كانت من نفوس الدهماء، أو تنتصر للحق الذي هي عليه إن كانت من نفوس الأنبياء والعلماء والأولياء، وكل تقي ولي لله سبحانه وتعالى.
والصفح في لسان العربية هو الإعراض عن اللقيا بما لا يحب، يقال: صفح عنه أي: أعرض عن عقوبته، بل عن ملامته، وعن ذكر ذنبه، بل عن تذكره، وتلك مقامات علية متصاعدة من الصفح، ففي الصفح إقبال وبشاشة وجه، ولذا جاء منه التصافح، وهو الأخذ باليد، أي أن يضع الرجل صفح كفه في صفح كف الآخر. وهذا يقتضي إقبال الوجه على الوجه، وهذا فيه رمز إلى ما قام في القلب من القبول والإقبال، ومن هنا شرعت المصافحة بين الرجال بعضهم بعضا، وبين النساء بعضهن بعضا، إيذانا بالقبول والإقبال..
وجمال الصفح المأمور به، هو الصفح الآتي من قوة نفسية وقوة واقعية، وليس صفح العجزة والضعفاء هو الصفح الذي كان من النبي " صلى الله عليه وسلم" يوم الفتح: حين أطلقهم، ولم يعاقبهم (1)، وكان بملكه " صلى الله عليه وسلم" أن يقطع الأعناق، ولا ملامة عليه، ولكنه الحكيم، والنازل على ما أمره به الله سبحانه وتعالى، والعليم بأن فعل الصفح فيهم وفيمن يأتي من بعد أعظم وأنجع من فعل الانتصار في كل منازلة من منازلات الحرب.
هو صفح جميل من أنه خارج من فتوة نفسية وقوة عملية، وهو صفح جميل من أن أثره الجليل الجميل لا يطاول.
والصفح الجميل سجية من سجاياه " صلى الله عليه وسلم" . روى البخاري في كتاب «التفسير» من صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمرو ابن العاص - رضي الله عنهما - أن هذه الآية التي في القرآن {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا } (الأحزاب:45)، قال في التوراة: «يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا». (حديث رقم: 4838).
ومن الصفح الجميل ما راوه مسلم في كتاب «الجهاد والسير» من صحيحه بسنده عن أنس "رضي الله عنه" أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة "رضي الله عنه" فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله " صلى الله عليه وسلم" : «ما هذا الخنجر؟». قالت: «اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه». فجعل رسول الله " صلى الله عليه وسلم" يضحك. (2)
قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء. انهزموا بك. فقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم" : «يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن». (حديث 4783)
أرأيت إلى قوله " صلى الله عليه وسلم" : «يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن»، هذا من الصفح الجميل الذي يؤتي من الثمر أطيبه.
وهو " صلى الله عليه وسلم" لم يكتف بأن لم يعاقب، بل لم يعاتب الطلقاء إذ أدبروا يوم حنين، وخلفوا رسول الله " صلى الله عليه وسلم" ، وما كان لهم أن يفعلوا، بل كان منه " صلى الله عليه وسلم" ما هو أجمل، اقتسم فيهم وفي المهاجرين الغنائم، ولم يمنح الأنصار شيئا، مما حاك في نفس ثلة من الأنصار، فقالت ما قلت، فكان من مكافأة النبي " صلى الله عليه وسلم" أن قال لهم مقالة، هي عز الدنيا وسعادة الآخرة، حين قال قالت ثلة منهم:
إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك، فجمعهم في قبة، فقال " صلى الله عليه وسلم" : «يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟»! فسكتوا، فقال: «يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا، وتذهبون برسول الله " صلى الله عليه وسلم" تحوزونه إلى بيوتكم؟».
قالوا بلى. فقال رسول الله: " صلى الله عليه وسلم" «لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار» (3)
أرأيت إلى الصفح الجميل مع الطلقاء، والحكمة الجميلة مع الأنصار؟!
ومن هذا ما رواه البخاري في كتاب «الأدب» من صحيحه بسنده عن أنس ابن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله " صلى الله عليه وسلم" وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة - قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي " صلى الله عليه وسلم" وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته - ثم قال: «يا محمد، مر لي من مال الله الذى عندك. فالتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعطاء». (حديث 6088)
وجاء في كتاب «البر والصلة» من جامع الترمذي بسنده عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلى يقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله " صلى الله عليه وسلم" فقالت: «لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح». (حديث رقم: 2148). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وكان " صلى الله عليه وسلم" يحث أصحابه على الصفح، وأن لا يسارعوا إلى العقوبة، بل ليكن العفو مبدأ أمرهم ومنتهاه، وإن وقع من بعضهم ما يستوجب الحد.
روى أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عبدالله بن مسعود بسنده عن شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر قال: سمعت أبا ماجد - يعني الحنفي - قال: كنت قاعدا مع عبد الله - قال - إني لاذكر أول رجل قطعه، أتي بسارق فأمر بقطعه وكأنما أسف وجه رسول الله " صلى الله عليه وسلم" قال: قالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه.
قال " صلى الله عليه وسلم" : «وما يمنعني ؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم».
إنه ينبغى للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه.
إن الله عز وجل عفو يحب العفو {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. (النور: 22)
وجعل الصفح عمن أساء من أفضل الفضائل، لأن في هذا دفعا للسيئة بالحسنة، كما أمر كتاب الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (فصلت: 34)
روى أحمد بن حنبل في مسنده من حديث معاذ بن سهل "رضي الله عنه" ، بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله " صلى الله عليه وسلم" أنه قال: «أفضل الفضائل أن تصل من قطعك, وتعطي من منعك، وتصفح عمن شتمك». (حديث:16023)
هذه الثلاثة التي هدى إليها نبي الرحمة " صلى الله عليه وسلم" إنما يقوم له أولو الفتوة النفسية، لأن للقيام لها فضلا عن القيام بها استحقاقات رجولية بالغة، لايلقاها إلا الصابرون صبرا جميلا.
وإن لحضورها في أي أمة فضلا عن شيوعها أثرا جليلا وجميلا في تماسك الأمة، وتحقيق سلامها الاجتماعي، فتنعم بنعمتي الأمن والكفاية. وتلك نعمة الدنيا:
روى البخاري في كتابه «الأدب المفرد»، باب: «من أصبح آمنا في سربه» بسنده عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه - عبيد بن محصن اختلف في صحبته - عن النبي " صلى الله عليه وسلم" قال: «من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا»: (حديث: 300)، ورواه الترمذي، وابن ماجه.
ذلك هو نبي الرحمة، ونبي الحكمة " صلى الله عليه وسلم" . فهل لنا أن نحمل من ميراث رحمته بأمته، ومن ميراث حكمته، ما يجعلنا أهلا لأن نحوز شرف وراثته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
فالصفح عمن أساء، ودفع السيئة بالحسنة عامل عظيم الأثر في تحقيق مجتمع متماسك متراحم، وهذا ما نفتقر إليه. إن هذا ما يفتقر إليه كل قائد فتي قوي مع خصومه. ولكن هذا يحتاج إلى علي الحكمة، يعرف الأرض التي ينبت فيها الصفح ويورق ويزهر ويثمر، فإن كان من الخصوم من لا يصلح معه ذلك الصفح فلا يكون، كما فعل مع بني قريظة، لما كان منهم من خيانة في غزوة الأحزاب. فمثلهم يزيدهم الصفح فجورا، فلا يكون الصفح حينئذ جميلا. لأنه سيثمر قبحا، ويزيد العتو عتوا.
فالصفح الجميل عمن يصلحه الصفح قائم لم ينسخ بالأمر بالقتال، كما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال الطبري:
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد (فاصفح الصفح الجميل) قال: هذا قبل القتال.
حدثني المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن عيينة، في قوله: {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} وقوله: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} قال: كان هذا قبل أن ينزل الجهاد. فلما أمر بالجهاد قاتلهم فقال: «أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، وبعثت بالحصاد، ولم أبعث بالزراعة».
أما آية السيف فهي قائمة لمن لا يصلحه الصفح الجميل. وخصوم الدعوة ليسوا سواء، فلا يكون منهج التعامل معهم واحدا، فذلك منطق الحكمة في الدعوة.
ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله " صلى الله عليه وسلم" ولنا معه في سورة (النحل): {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (النحل:125).
جعل له ثلاثة سبل إلى تحقيق الدعوة: الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، ذلك أن الناس أربعة:
منهم من يسمع ويقبل، فهذا سبيل دعوته الحكمة، ومنهم من يسمع ويقبل، ولكنه لايقبل لما يحيط به من الشهوات الصارفة، فهذا سبيل دعوته الموعظة الحسنة. وهذان الضربان متقاربان، ولذا كان النظم القرآني المتعلق بدعوتهما واحدا {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} عطف سبيل الموعظة الحسنة على سبيل الحكمة.
ومنهم من يسمع ولا يقبل، بل يجادل ويعارض ويناكد، ولكنه لا يرفع سيفا. وهذا سبيله الجدال بالتي هي أحسن. وهذا ما حملته الآية الكريمة في سورة النحل.
وهذا الضرب ليس من باب الضربين الأولين، ولذا التفت عن النظم الذي كان للضربين الأولين، فلم يقل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فلو قال لفهم من العطف أن هذا الضرب الثالث من باب الضربين الأولين، ولكن البيان القرآني عدل عن النهج الأول في النظم والصياغة، واستفتح طريقة جديدة، فقال: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، فهو عطف على فعل الأمر الذي في صدر الآية {ادْعُ} مما يفهم أن هذا السبيل ليس من باب السبيلين الأولين، إشارة إلى أن الضرب الثالث مغاير للضربين الأولين، وهذا نهج من السنة البيانية للقرآن الكريم في إفهام دقائق المعاني ولطائفها.
وكل هؤلاء الثلاثة الأضرب يصلح معهم، ويصلح من أحوالهم الصفح الجميل، وهذه الأصناف الثلاثة باقية ما بقيت الحياة. مما يجعل الأمر الإلهي للنبي " صلى الله عليه وسلم" ولأمته من بعده {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} أمرا باقيا ما بقيت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
ويبقى الصنف الأخير من الناس: من يسمع، ولا يقبل ألبتة، بل يشهر سيفه ليمنع الدعوة من أن تبلغ غيره، فهو لا يكتفي بأن يعرض هو عنها، بل يسعى بسيفه وما ملكت يمينه من القوى إلى أن يحاجزها عن أن تبلغ مسامع الآخرين. فيتخذوا ما شاءوا طوعا لا قهرا، لأنه يعلم أنها إن بلغت مسامعهم، فإنها ستحرك ساكنا في كثير منهم، ومنهم من سيستمع، ويقبل، وهذا الضرب الرابع من الناس هو الذي جاء الأمر بقتاله، لا بقتله، فليست الغاية ألبتة قتله، وإن سل سيفه، بل الغاية قتاله، ليكف سيفه. فإن كفه، فلا يقاتلن فضلا عن أن يقتل. فإن الإسلام دين الحياة في سبيل الله، وليس دين الموت في سبيل الله، بل الموت في سبيل الله تعالى حين لا تتحقق الحياة للناس في سبيل الله إلا بموت ثلة من المسلمين في سبيل الله تعالى، تحقيقا لتلك الحياة للآخرين، وهذا هو منهج الإيثار، وذلك هو جليل الجود، وجميل السخاء.
الهوامش
1- تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط (1) 1420هـ، مؤسسة الرسالة، ج17، ص128.
2- حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري.
3- صحيح البخاري (المغازي)، حديث رقم: (4337)، ورواه مسلم في كتاب (الزكاة) رقم: (2488).