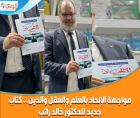- الثلاثاء، 17 مارس 2015 09:04
- كتب بواسطة: adminkw

أ.د. أمان عبد المؤمن قحيف :
الأمن المجتمعي خاصية تتصف بها المجتمعات المتحضرة والأمم المتقدمة، فأنت لا تجد أمة متخلفة علميًّا وتكنولوجيًّا تنعم بتوافر الأمن والهدوء لأفراد مجتمعاتها، تمامًا مثلما يعز عليك أن تجد أمة نجحت في ارتياد آفاق التحضر والرقي وتعاني في الوقت نفسه من غياب الأمن المجتمعي الذي يحقق السكينة لكل أفرادها، وتعد المجتمعات الأوروبية والأميركية المتقدمة وبعض المجتمعات الأفريقية المتخلفة علميًّا أوضح الأمثلة على ذلك.
ولما كانت العبادة السليمة لا تتحقق، شأنها شأن عمارة الأرض، إلا في ظل جو من الأمن المجتمعي فقد حرص الإسلام الحنيف أشد الحرص على أن يتوفر للناس أمنهم، ويتوفر لهم الجو المناسب الذي يضمن فيه الإنسان صيانة ماله وعرضه وولده من التلف أو التعرض للمخاطر.
ويتبين للمدقق في تعاليم الإسلام الحنيف وتشريعاته أنها تصب في النهاية في مصلحة أن يعيش الناس في جو من السكينة والاطمئنان النفسي والروحي، فالله تعالى عندما حرم الزنا- مثلا- أراد من ذلك ألا يحدث أي نوع من التطاول أو الاعتداء على أعراض الناس، لأن ذلك يؤدي إلى اندلاع الخلافات والمشاحنات بينهم، ويؤدي أيضًا إلى ضياع الأنساب وانتشار الأمراض المستعصية- كالإيدز- مثلًا، ذلك المرض الذي انتشر في الحضارات التي لا تعيش حياتها وفقا للتعاليم والتشريعات الدينية التي تحض على فضائل الأعمال وتؤكد القيم الأخلاقية السامية.
هكذا يتأكد لدينا أن تحريم الإسلام للفاحشة يعد هو الآخر طريقًا نحو تمهيد الفضاء المجتمعي للأمة كي تعيش في حالة من الأمن والاستقرار والتوافق بين مكونات المجتمع التي تشكل بنيته العامة .
من هذا المنطلق يتبين لنا أن الإسلام كان حريصًا على أمن المجتمع واستقراره عندما حرم الزنا، ويقاس على ذلك تحريمه للكذب، والغيبة، والنميمة، وقتل النفس بغير الحق، والخداع، وسب الآخرين أو لعنهم، أو التطاول عليهم...إلخ من الأمور والمسائل التي حرمتها الشريعة الإسلامية، بهذا يكون التشريع قد جاء ليؤكد في الكثير من المواضع على حرص الإسلام الحنيف على توفير الأمن المجتمعي للناس جميعًا، الأمر الذي يفيد أن من يتطاول على الناس، أو يتسبب في ترويعهم، أو قض مضاجعهم، أو الإساءة إليهم بالقول أو الفعل، أو من يتسبب في إرهابهم وتخويفهم، كل من يفعل هذا أو يقدم عليه تتعارض سلوكاته تلك من حيث المعنى والمضمون مع ما أمرت به الشريعة وأقره الدين الحنيف.
إن الشريعة الإسلامية التي جعلت تبسم الإنسان في وجه أخيه صدقة لا يمكن أن توافق أو تبيح بحال من الأحوال لإنسان أن يتسبب في إرهاب الناس أو تخويفهم أو ترويعهم أيا ما كان هؤلاء الناس، وأيًا ما كانت مذاهبهم ومللهم وعقائدهم، لأن الله عز وجل أرسل نبيه ص رحمة للعالمين جميعًا سواء من آمن منهم به أو من لم يؤمن به، قال تعالى في محكم التنزيل: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (الأنبياء: 107)، ومعلوم أن النبي ص هو المثل والقدوة والأسوة الحسنة للمسلمين، كل المسلمين، قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا} (الأحزاب: 21)، من هنا كان على المؤمن أن يكون داعية خير ورسول سلام أينما كان وحيثما كان، لا فرق في ذلك بين وجوده في دار الإجابة أو في دار الدعوة، فالمؤمن لا يخيف الآخرين، ولا يرعبهم، ولا يقض مضجعهم، ولا يقلق أمنهم العام.
ولقد أراد الإسلام الحنيف من الناس أن يتعاملوا برباطة جأش وقوة إرادة مع الملمات التي قد تتعرض لها الأمم والشعوب في مراحل حياتها وتطورات تاريخها، فلا يجب الجزع، أو الهلع، أو الخوف، أو الانهيار النفسي عند حدوث طارئ ما، بما يؤثر سلبًا على حالة المجموع، ويؤدي إلى شيوع وإشاعة الرعب بين الناس، إذ يجب من الناحية الشرعية مواجهة الأمور بحزم وعزم ورباطة جأش، وهنا يشير الإسلام إلى ضرورة الاستفادة ممن يمتلك القدرة على توجيه الأمور نحو الوجهة الصحيحة والسليمة، بمعنى أنه لابد من أن يوسد الأمر إلى أهله، حتى يتمكن المجموع من النجاة من الملمات التي قد تصيب الناس على مختلف طوائفهم ومذاهبهم، قال تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا} (النساء: 83).
والإسلام الذي جعل من قواعده الأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينهى عن ترويع الناس، كل الناس، ذلك لأننا إذا قسمنا الأمور إلى «منكر ومعروف» فإن المرء لا يتردد للحظة واحدة في أن يضع مسألة ترويع الناس وتخويفهم ضمن المنكر الذي جاء الإسلام الحنيف لينهى كل الناس عن إتيانه أو الإقدام عليه، بل إن ديننا الحنيف جعل خيرية هذه الأمة تكمن في أمور عدة من أوائلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأكثر من ذلك أنه ذهب إلى أن شرط تحقق خيرية هذه الأمة يكمن في كونها تمارس الدعوة إلى الخير وتنهى عن المنكر والشرور، بعد إيمانها بالله تبارك وتعالى، قال عز وجل في هذا المعنى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} (آل عمران:110).
ونظرًا لتأكيد الأسلام على أهمية الأمن المجتمعي للحياة البشرية فقد جعله الله تبارك وتعالى بمنزلة إحدى المكافآت الكبرى التي يتحصل عليها المؤمنون جزاء إيمانهم بربهم والتزامهم بالمنهج السماوي في حياتهم الخاصة والعامة، أو في عباداتهم ومعاملاتهم، فالله تبارك وتعالى عندما يستخلف المؤمنين في الأرض، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم ويبدل الخوف في حياتهم أمنا، ويجعلهم يعيشون في طمأنينة وأمان، فإن ذلك كله يأتي كنتيجة لكونهم من أهل الإيمان والطاعة الخالصة الذين لا يرتدون إلى الكفر والفسوق، قال تعالى في محكم كتابة الكريم: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون } (النور: 55).
من ثم فإن من يعكر صفو المجتمع بتهديد الأمن فيه يعد فاعلًا للمنكر لا محالة، وهو منفلت من تعاليم الإسلام الشرعية التي حرصت على المحافظة على حياة الناس وأموالهم وأنفسهم، ومعلوم أن تلك الأمور من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية الغراء.
ولقد اشتملت سيرة رسول الله ص على العديد من المواقف التي تؤكد حرصه ص قبل البعثة وبعدها، على أن يكون الأمن المجتمعي متحققًا في أهله وقومه إلى أبعد مدى ممكن، فالثابت من كتب السير أن الناس هرعوا في صباح يوم من الأيام على سماع أصوات وجلبة حول مكة مما حرك مخاوفهم وأزعج نفوسهم، فهرعوا الى خارج مكة يتساءلون: ما الخطب؟ واذا بهم يرون رسول الله ص قد سبقهم الى استكشاف الأمر، وعاد ليطمئنهم جميعا بأنه لا شيء يدعو للخوف ولا للهلع أو التوتر، وهذا الأمر يكشف من جهة عن شجاعته وشهامته ص ويكشف في نفس الوقت عن حرصه على ان يكون مجتمعه الذي يعيش فيه ويحيا بين جنباته آمنا مستقرًّا طوال الوقت، أما بعد بعثته فقد كان ص من أحرص الناس على إشاعة الطمأنينة في النفوس وتكريس الأمن في المجتمع، لدرجة أنه ص لم يكن يحب أو يقبل أن يحدث أي نوع من أنواع التوتر في العلاقات بين الذوات الإنسانية المفردة من بني قومه، فضلاً عن حرصه على المجتمع ككل متكامل.
ولقد حرص الرسول ص على شيوع الأمن بين الأفراد والأسر داخل بنية المجتمع الواحد حتى في أبسط الأمور، لذلك كان يأمر المسلمين بأن من أعد مرقًا فعليه أن يكثر منه ليعطي جيرانه من هذا المرق، وأكثر من توصيتهم بالجيران خيرًا، ونقل لهم أن جبريل \ مازال يوصيه بالجار حتى ظن النبي ص أن الشرع سيعطي للجار حقًا أو جزءًا من الميراث.
كل هذه مسائل كانت تهدف ضمن ما تهدف إليه إلى تحقيق درجة عالية من التآخي، والتواصل، والتعاون، والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد، تلك الأمور التي تصب في النهاية في تكريس الأمن والأمان للذوات الإنسانية المقررة، بل للمجتمع بشكل عام.
إن حرص الإسلام على استتباب الأمن يرجع إلى أمور عدة نذكر منها ما يلي:
أولًا: إن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على حياة الناس وأموالهم، ومعلوم أن استتباب الأمن يحافظ على الحياة والأموال، لأن افتقاد المجتمع للأمن يؤدي بالتالي إلى تعرض جميع الأنفس والممتلكات للتهلكة، والنهب، والتدمير، بهذا يأتي الحرص على الأمن المجتمعي في صدارة ما يأمر به الإسلام وما تهدف إليه مختلف القوانين الأخرى.
ثانيًا: إن الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على تقليم أظافر أولئك الأفراد الذين يعيثون في الأرض فسادًا، حتى وإن ادعوا أنهم من أصحاب القلوب الطيبة والأفئدة النقية، ومعلوم أن انتشار الفساد في أي مجتمع من المجتمعات يؤدي بالضرورة إلى افتقاده للأمن، الأمر الذي يتيح لهؤلاء الأفراد الخارجين على الدين والقانون أن ينشطوا في الإفساد في الأرض، وهذا على خلاف مراد الله تبارك وتعالى في الكون، لذلك توعد الله عز وجل هذا الصنف من الناس بجهنم وبئس المصير، قال تعالى في هذا المعنى: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد} (البقرة: 204-206).
ثالثًا: المحافظة على إيجاد جو عام يناسب ممارسة العبادة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن كلا من العبادة والدعوة في حاجة ماسة وضرورة إلى أجواء هادئة ومستقرة، يكون من شأنها اتاحة الفرصة للدعاة إلى الله أن يمارسوا عملهم في سكينة وروية، ويسهم في مساعدتهم في الأخذ بيد الأمة نحو الالتزام بالمبادئ الدينية والقيم الأخلاقية، الأمر الذي يهيئ المجتمع كله لتلقي جزاء الله تعالى وثوابه والفوز بالسعادة لكل فرد من أفراده، لأنه إذا مارست مجموعة معينة من الناس بعض الأفعال السلبية والخاطئة فإن الأمور قد تعود بالضرر على مختلف أفراد المجتمع وجميع أبنائه، وصدق الله العظيم القائل: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} (الأنفال: 25)، فالفتن أو السلوكات الشاذة تجلب على المجتمع كله ما لا يرضاه من المسائل والأمور، على النحو الذي يحذر منه الرسول ص في حديثه الذي جاء فيه: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا» (رواه البخاري).
رابعًا: المحافظة على إيجاد جو عام مناسب للعمل والانتاج وعمارة الأرض، فالله تبارك وتعالى كلف الإنسان بالسعي في الأرض وإعمارها لكي يأكل منها حلالًا طيبًا، قال عز وجل: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} (الملك: 15).. وغني عن البيان أن الإشارة إلى المشي في مناكب الأرض يفيد معنى الاجتهاد في الأخذ بأسباب طلب الرزق الحلال، تلك الأمور التي لا تتحقق إلا في ظل جو عام يتسم بالأمن والطمأنينة والهدوء.
ويجب أن ندرك جميعًا أن تحقيق الأمن المجتمعي ليس مسؤولية الدول والحكومات وحدها، بل هو قضية يجب أن تسهم فيها كل قطاعات الشعوب من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومختلف القوى والفعاليات التي يتشكل منها البناء العام للأمة والمجتمع.